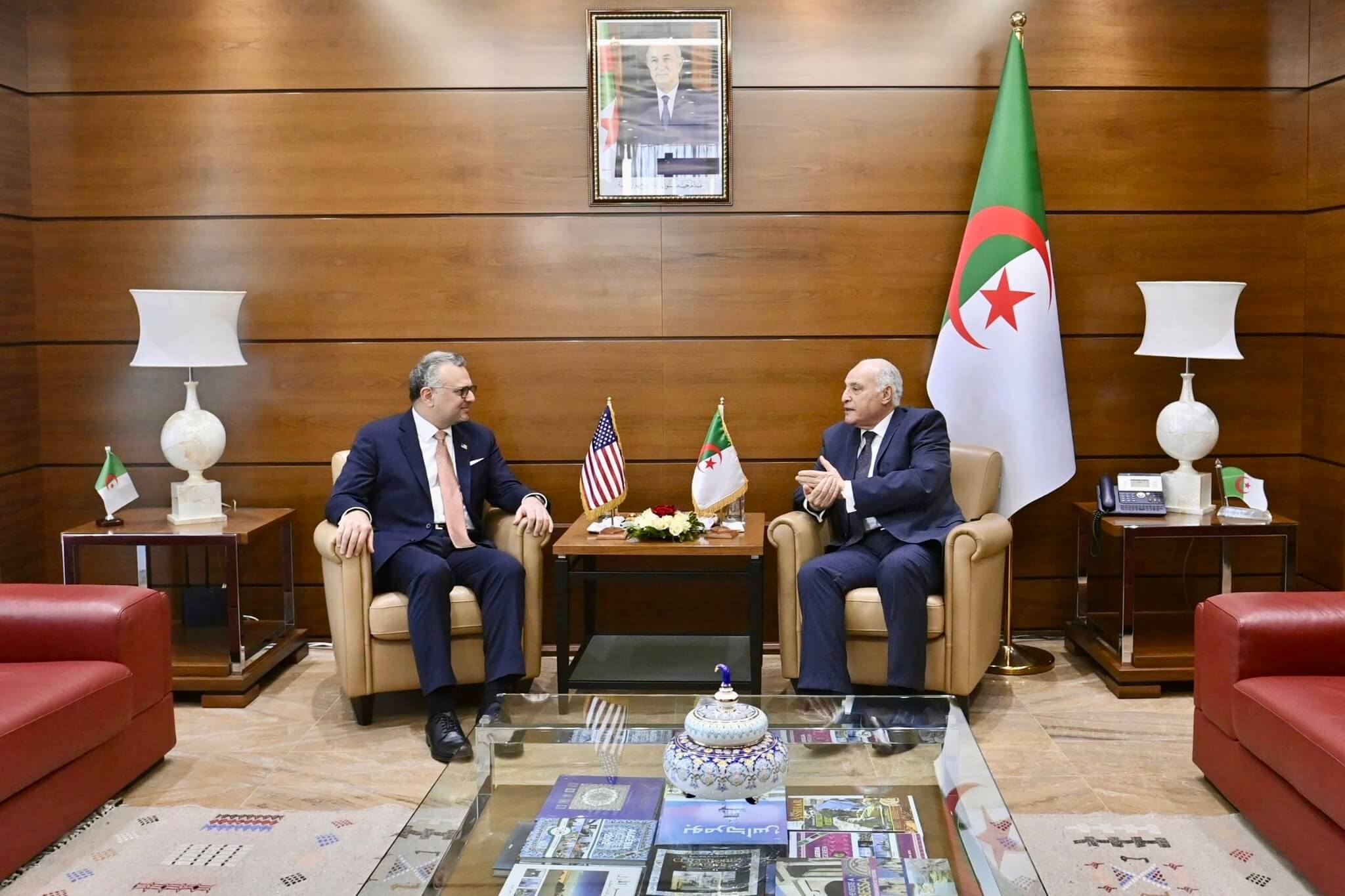العقدة الغوردية.. تشريح سيميائي لأزمة المعنى والتمثيل في السياسة المغربية
مقدّمة: دولة تتحرّك وأحزاب تتصلّب
لا يعيش المغرب اليوم أزمةً سياسيةً بالمعنى الكلاسيكي للكلمة؛ فلا انهيار في المؤسسات، ولا فراغ دستوري، ولا انقطاع في استمرارية الخدمات العمومية. ومع ذلك، يَسِمُ المشهدَ ما يمكن وصفه، مجازاً، بـ«الموت السريري للسياسة». فالدولة تواصل عملها وتؤمّن الخدمات، في حين يتراجع الجوهر السياسي بوصفه فعلاً تمثيلياً، ومجالاً للتنافس الديمقراطي، وآليةً لإنتاج المعنى الجماعي. ولا يُقصد بهذا «الموت السريري» غياب الحياة السياسية، بل توصيف وهنٍ بنيوي في الفاعلية والشرعية. فالنقاش العمومي لا يزال ينبض حول قضايا مركزية كالتعليم والصحة والنموذج التنموي، كما يشهد البرلمان والمجتمع المدني لحظات اشتباك دلالي متفاوتة القوة.
غير أنّ هذا النبض يظل متقطعاً، ضعيف الأثر، وعاجزاً عن التحوّل إلى دينامية تمثيلية منتظمة. ويعكس هذا التحول انتقالاً في لغة الفعل العمومي، من التواصل المباشر إلى مستوى أعمق تغلب عليه دلالاتٌ رمزية مختلّة، إذتتبنّى مشاريع الدولةباعتبارها آفاقاً سيميائية كبرى تتجاوز منطق الأداء اليومي. وهنا تكمن المفارقة المركزية: فالدولة تتحرّك في أبعاد استراتيجية ورمزية متقدّمة، في حين تعجز الوسائط التقليدية عن تفعيل «آلية التأويل» التي تربط هذه المشاريع بالمعنى الاجتماعي الملموس، ما يوسّع فجوة الثقة.
من جهة أخرى، لا يعني هذا التحوّل غياب السلطة، بقدر ما يدلّ على تبدّل عميق في طبيعة شرعيتها: من شرعية تُنتَج عبر التمثيل والمساءلة، إلى شرعية تُدار عبر هندسة الرموز. وهو ما يفضي إلى معضلة مركزية لافتة عند المواطن المغربي: دولة في حركة صاعدة، وسياسة في جمود متصلّب.
ولا يعني هذا التشخيص كذلك إنكار البنية الدستورية والمؤسساتية للنظام السياسي المغربي، الذي يقوم على توازن معقّد بين ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، كما ينصّ الفصل الأول من الدستور، واختصاصات تنفيذية وتوجيهية للملك بصفته أمير المؤمنين وضامن دوام الدولة ووحدتها، وفقاً للفصل 42.
كما يضمّ هذا النسق مؤسسات دستورية وهيئات مستقلة تؤدي أدواراً حيوية، وإن ظلّ أداؤها متفاوتاً من حيث التأثير والنجاعة. فالأزمة، في جوهرها، ليست أزمة غياب مؤسسات، بل أزمة تفاعل أدوارها وقدرتها على إنتاج معنى سياسي مشترك.
ولا يكتمل فهم هذا التحوّل في منطق الشرعية دون استحضار السياقات الاقتصادية والجيوسياسية التي تُمارس ضغطاً مستمراً على أولويات الفعل العمومي. فالدولة تتحرّك، في آنٍ واحد، تحت وطأة رهانات تنموية داخلية تفرض تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الإدماج المهني، وفي بيئة إقليمية ودولية تتّسم بتنافس متزايد وحساسية استراتيجية عالية.
ويُسهم هذا التداخل في ترجيح منطق الفعالية والسرعة في اتخاذ القرار، بما يجعل من «الإنجاز» دالاً مركزياً لإنتاج الثقة والشرعية، وينعكس، في المقابل، على موقع المداولة التمثيلية. وبهذا المعنى، ربما لا تعمل هذه السياقات على تعزيز «شرعية الإنجاز» فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تأجيل الإصلاح التمثيلي العميق، الذي يُعاد تأطيره ظرفياً كمسار معقّد قد يُربك توازنات قائمة أكثر مما يقدّم حلولاً فورية.
وعليه، لا تبرز الأزمة السياسية في المغرب كمجرّد فراغ دلالي عابر، بل هي حصيلة مسار تاريخي لإعادة هيكلة الحقل السياسي، حيث يُستبدل منطق الشرعية التمثيلية بشرعية الإنجاز ومنطق «أصحاب المصلحة»، وتُهجَّر السياسة تدريجياً من الأحزاب إلى دوائر التكنوقراطية والمؤسسات العمومية، ثم إلى الفضاء الرقمي بما يحمله من تبسيط وتسطيح للوساطة السياسية.
ويأتي هذا التحوّل في سياق دولي مضطرب تُعاد فيه هندسة القوة والتحالفات، وتتراجع فيه الوسائط التمثيلية التقليدية، بينما تشهد أفريقيا، في المقابل، صحوة جيوسياسية جديدة. وفي هذا المشهد المركّب، يبرز المغرب كفاعل إقليمي صاعد، في مقابل حقل سياسي داخلي يعجز عن مواكبة سرعة التحوّل ومتطلباته الرمزية.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن لحقل سياسي متآكل المعنى أن يواكب طموح دولة صاعدة؟ وكيف تُبنى الثقة إذا كانت الإحالة الاجتماعية والوساطة التمثيلية في حالة تراجع مستمر؟
هنا تتجلّى ما يمكن تسميته بـ«العُقْدة الغوردية Nœud gordien » للسياسة المغربية، أي تلازمٌ بنيوي بين مركزية قوية لإنتاج المعنى وضبط الإيقاع العام، ووسائط تمثيلية هشّة أو متآكلة، يجعل من كل إصلاح جزئي عاملاً في تعقيد الأزمة بدل تفكيكها، ويحوّل الاستقرار إلى اتزانٍ جامد لا يسمح بتداول رمزي حيّ في الهوامش والأطراف.
ولا يقتصر هذا النمط على الحالة المغربية بوصفها استثناءً، بل يندرج ضمن نموذج أوسع تشهده أنظمة سياسية اختارت ترسيخ الاستقرار عبر مركز شرعي قوي، مقابل إضعاف أو تحييد الوسائط التمثيلية. ففي مثل هذه النماذج من الحكامة، لا تُدار السياسة عبر التنافس السردي المفتوح، بل عبر ضبط الإيقاع العام ومنع الانزلاق، حيث تُصبح الشرعية نتاج هندسة دقيقة، لا حصيلة تدافع اجتماعي حيّ.
غير أنّ خصوصية الحالة المغربية تكمن في أنّ هذا الاتزان لم يُفرض قسراً، بل تشكّل تاريخياً عبر توافق ضمني جعل من الاستقرار قيمةً عليا، غير أنّه، في المقابل، أضعف قدرة الحقل السياسي على تجديد نفسه وإنتاج معنى مستقل.
أزمة المعنى: انفصال الدالّ السياسي عن الواقع
لا تختزل الأزمة السياسية في ضعف المخرجات الحكومية أو محدودية السياسات العمومية فحسب، بل تتجذّر، على نحو أعمق، في انفصال بنيوي بين الخطاب السياسي والواقع الاجتماعي. فقد تحوّلت مفاهيم مركزية من قبيل الديمقراطية والإصلاح إلى دوالّ عائمة، تُستَعمل في خطاب مشحون بالطوباوية أو الشعبوية، ومنفصل عن الإحالة الاجتماعية، بما يُنتج قطيعة سيميائية ثلاثية الأبعاد: لغة بلا مرجع واقعي، وتمثيل بلا ثقة، ومشاركة بلا أفق.
وبنهج «الطريقة التفكيكية»، يتضح أن هذا الانفصال تجلّى في التناقض الصارخ بين دولة تُعلن مشاريع كبرى واستراتيجيات طموحة، ومواطن واعٍ يطرح سؤالاً بسيطاً ومشروعاً: كيف تُترجَم هذه الوفرة الخطابية إلى ثقة محسوسة وتحسين يومي في شروط العيش؟
فالتعبير المعرفي المتخصص يبدو بعيدا عن اللغة اليومية للمواطن الذي يجد نفسه أمام خطاب مؤسساتي مغلق، يُحوِّل المجال العام إلى ساحة تهيمن عليها المفردات التقنية والرؤى الخاصة بالنخبة، مما يُحيل المواطن العادي إلى موقع المتلقّي السلبي، في حين تفتقد الوسائط الحزبية القدرة على فكّ شفرة الخطاب وتأويله وتحويله إلى أولويات اجتماعية ملموسة. ونتيجة لذلك، تتّسع الهوّة بين لغة مؤسساتية مصقولة وشعور اجتماعي متنامٍ بالاستبعاد، لتتحوّل السياسة إلى طقوس شكلية — انتخابات، تعيينات، خطابات، حكومات ائتلافية — تفتقر إلى الأثر التعبوي الحقيقي، وتغذّي الإحساس باللاجدوى، بما يقود، في حالات غير قليلة، إلى الرفض أو الانسحاب الصامت.
وتعزّز هذا المنحى معطيات استطلاعية حديثة تشير إلى تآكل حاد في الثقة بالمؤسسات المنتخبة (الحكومة، البرلمان، الأحزاب)، مقابل مستويات مرتفعة من الثقة في المؤسسات السيادية، وهو ما يعكس ثقافة سياسية تميل إلى تفضيل الاستقرار، وتشكيكاً متزايداً في جدوى الوساطة الحزبية.
بل إنّ الأزمة بلغت مستوى أشدّ خطورة، حيث لم يعد المواطن يكتفي بعدم التصديق، بل بات يُفكّك الخطاب الرسمي ويعيد تأويله بوصفه نصوصاً منفصلة عن واقعه المعاش، بما يهدّد وظيفة السياسة ذاتها كوسيط رمزي. وتتجسّد هذه القطيعة في مثلث سيميائي مأزوم (لغة بلا إحالة اجتماعية، تمثيل بلا ثقة، ومشاركة بلا أفق). وتتغذّى أضلاع هذا المثلث من بعضها بعضاً، بحيث يصطدم أي إصلاح محتمل بشروط مضادّة تُفرغه من مضمونه.
ومع أنّ هذا التشخيص يطال المشهد الحزبي في عمومه، فإنه لا يفترض تجانسه ولا يُنكر التمايزات التاريخية والتنظيمية بين الأحزاب، سواء من حيث المرجعيات أو التجارب الحكومية أو الحضور الترابي. غير أنّ القاسم المشترك بينها يظلّ عجزها، بدرجات متفاوتة، عن إنتاج سردية سياسية جامعة قادرة على استعادة الثقة والوساطة.
ففي ظلّ الدينامية المتسارعة التي يعرفها المغرب، تعيش معظم الأحزاب أزمة وجودٍ وظيفي وبنيوي، إذ تحوّلت بعضها — بفعل تاريخ طويل من التعدّدية المضبوطة والتحالفات التوافقية — إلى كيانات شبه إدارية تُدار بمنطق توزيع المواقع والمناصب والريع السياسي داخل دوائر ضيّقة تحكمها الزبونية وشبكات الولاء، أكثر مما تنتج رؤى أو حلولاً واقعية لإشكاليات المجتمع. كما انقلبت آليات التنظيم الداخلي، في كثير من الحالات، من أدوات لضمان التعددية والتداول إلى وسائل لـ«الاستثمار السياسي» تنتقي الأعيان وتُقصي الهياكل القاعدية، مخلّفة فراغاً تمثيلياً عميقاً وعجزاً بنيوياً عن التعبئة والإقناع.
أما الإعلام الوطني، فبدلاً من أن يضطلع بدوره كفضاء للنقاش العمومي العقلاني، غالباً ما يكتفي بخطاب تقريري أو تبريري نمطي، يفتقر إلى العمق والتحليل، ويعجز عن تأطير النقاش العمومي والمساهمة في التنشئة السياسية. وحين يُختزل دوره في النقل أو الترويج، ينشأ فراغ رمزي تملؤه المنصات الرقمية غير المؤطرة والسرديات الشعبوية، في وقت تحاول فيه السلطة ضبط فضاء لم يعد يخضع لمنطق الوساطة التقليدية. وهكذا، تنتقل الأزمة من كونها مؤسساتية إلى أزمة معنى شاملة تهدّد النسق الرمزي برمّته، وتستدعي إعادة تأهيل السياسة بوصفها فضاءً لإنتاج المعنى والمشروع المجتمعي، لا مجرّد تقنية للحكم أو أداة للإدارة.
المؤسسة الملكية كمصدر لإنتاج الرموز المركزية
في قلب هذا الفراغ الدلالي الذي أحدثته المنظمات الحزبية، تُدير المؤسسة الملكية الشرعية عبر ترميز مركّب يجمع بين الدلالات الدينية–التاريخية (إمارة المؤمنين)، والدلالات الحداثية–التنموية (الاستباقية، والمشاريع الاستراتيجية المهيكلة)، فضلاً عن البعد الكاريزمي–الرمزي (الحضور، والتوجيه، وتقييم الأداء). ويشتغل هذا الرمز السيادي، المتوافق عليه تاريخياً، كمصفاة سيميائية تُنقّي العلامات وتعيد توجيهها عبر ثلاث قنوات متداخلة: شرعية تقليدية، وشرعية عصرية، وشرعية دلالية.
وأمام تآكل الشرعية التمثيلية التقليدية، لم تكتفِ رئاسة الدولة بالتدبير التقني المحض لبعض الملفات الحساسة، بل انتقلت إلى هندسة ما يمكن تسميته بـ«شرعية بديلة»، تقوم على توظيف العلاماتالفائقة (Hyper-signes)، أي تلك الرموز التي تتجاوز وظيفتها الاقتصادية أو التقنية لتؤدي وظيفة دلالية تهدف إلى إنتاج صورة التفوق والنجاعة.
وتتجسّد هذه العلامات في المشاريع المهيكلة الكبرى التي لا تكتفي بخاصية رؤيتها بعيدة المدى وبأثرها التنموي، بل تمارس وظيفة سيميائية تُسهم في حجب «الموت السريري للسياسة» عبر الاستعمال الرمزي الذي يجسّد الحداثة والقوة والقدرة على النهضة.
وبالموازاة، يُستدعى خطاب «يوتوبيا الدولة الاجتماعية» بوصفه دالاً جامعاً، يُستخدم لملء الفراغ الأيديولوجي وإعادة ترميم العقد الاجتماعي على مستوى الخطاب، حتى وإن ظلّت ترجمته الواقعية متعثّرة بفعل ضعف أداء الحكومة ومحدودية الوساطة السياسية.
فالمؤسسة الملكية في المغرب لا تقود مسار النهضة فحسب، بل تُشكّل إطارها الرمزي والاستراتيجي والشرعي، من خلال مبادرات استباقية، وخطاب موجز كثيف الدلالات، وهندسة دقيقة للمشاريع المهيكلة، وقرارات جيوسياسية أعادت رسم خريطة التحالفات الخارجية، ورسّخت منسوب الثقة لدى المغاربة. وبالتالي، تشتغل كآلية لإنتاج «عمق دلالي» و«تعدد دلالي» كإشارات إلى عملية «تعويض دلالي» مُحكمة، لملأ الفراغ الناتج عن تراجع التأثير السياسة التمثيلية على الساحة المغربية.
وتتجلّى هذه القيادة في الهندسة الاستراتيجية لمشاريع كبرى شملت منظومة الطاقات المتجددة، والبنية التحتية المتقدمة، والاقتصاد المعرفي، والاقتصاد الأزرق، كما تظهر في قرارات جيوسياسية مفصلية أعادت تموضع المملكة إقليمياً ودولياً. ويوازي ذلك تفعيل دبلوماسية اجتماعية وقيمية تضع الإنسان المغربي في صلب الاهتمام، سواء عبر نموذج «الدولة الاجتماعية»، أو من خلال تعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي في السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا والعالم العربي.
وبذلك، لا تكتفي الملكية بدور «القائد»، بل تمارس دور «مهندس المعنى» و«حارس التوازن» داخل نظام سياسي مركّب، تُوجّه فيه مسار النهضة مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والهوية الحضارية، بما يجعلها مرتكزاً للاستمرارية والتجديد في آنٍ واحد.
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار تنظيم مونديال 2030 علامةً فائقة لإنتاج سردية بديلة، تُرسّخ صورة «حكومة المونديال» التي تستمدّ شرعيتها من الإنجاز التقني لا من التمثيل السياسي. كما تُقدَّم انتخابات 2026، لا بوصفها لحظة تنافس سياسي بقدر ما تُؤطَّر كضرورة وظيفية لضمان الاستقرار المطلوب لإنجاح هذا «المشروع الوطني».
غير أنّ نجاح الرموز المركزية في ملء الفراغ يكشف الوجه الآخر للمفارقة: فكلما ازدادت قدرة المصدر المركزي على إنتاج المعنى الجامع، ازداد المحيط السياسي عجزاً عن توليد معنى مبتكر، أو حتى عن مواكبة مشروع النهضة القائم. وهنا تتجسّد «العُقْدة الغوردية» بوصفها تركيباً تاريخياً يشتغل بمنطق الاتزان:
اتزانٌ يضمن الاستقرار، لكنه يُضعف التداول الرمزي، ويحدّ من قدرة السياسة على التجدد دون أن يمس النظام بشكل عام.
الأحزاب السياسية: من الفاعل التمثيلي إلى الواجهة الإدارية
وبما أن هذه الحالة تطال المشهد الحزبي في عمومه، فإنه لا يفترض تجانسه ولا ينفي التمايزات التاريخية والتنظيمية بين الأحزاب، سواء من حيث المرجعيات أو التجارب الحكومية أو الحضور الترابي. غير أن القاسم المشترك بينها يظل عجزها، بدرجات متفاوتة، عن إنتاج سردية سياسية جامعة قادرة على استعادة الثقة والوساطة.
لكن لا بد من الاعتراف أنه في ظلّ الدينامية المتسارعة التي يعرفها المغرب، تعيش معظم الأحزاب السياسية، في المقابل، أزمة وجودٍ وظيفي عميقة، حيث تحوّلت — بفعل تاريخ طويل من التعدّدية المضبوطة والتحالفات التوافقية — إلى كيانات شبه إدارية، تفتقر إلى الاستقلالية الفكرية، والرؤية المجتمعية، والقدرة على التعبئة والإقناع.
من الجانب السيميائي البحث، تكمن أزمة الأحزاب في بقائها حبيسة خطاب مباشر وسطحي، يراوح في المفردات البرنامجية التقليدية والوعود المكررة. بينما انتقلت ديناميات الدولة والمجتمع إلى مستوى أكثر تعقيداً، قائماً على الرمز والإنجاز والتفاعل مع تحولات العصر السريعة. في الواقع، لقد فشلت الأحزاب في استنباط معنى جديد أو تطوير رؤية مجتمعية قادرة على تفسير هذه التحولات للمواطن. فانشغالها أضحى منحصرا في تدبير شكلي وإداري، يفتقر إلى إمكانية التجديد الرمزي والفكري القادر على استنهاض ثقة الناخب فضلاً عن مواكبة طموح الدولة الصاعدة.
ويمكن توصيف الحزب المغربي المعاصر باعتباره تنظيماً بلا سردية مجتمعية واضحة، وبلا ذاكرة نضالية قابلة للتحديث، وبلا قاعدة رمزية قادرة على الاستنهاض. ونتيجة لذلك، تنزاح وظائفه من إنتاج البدائل وصياغة المشاريع إلى التأطير الانتخابي الموسمي، وتدبير المواقع، وامتصاص التوترات الاجتماعية. فمثل هذا التنظيم، لغته مجترّة، وشعاراته مستهلكة، ووعوده لا تُترجم إلى أثر ملموس؛ إذ لم يعد الحزب ينتج سرديات بديلة، بل ينجز وظائف تقنية صِرفة.
وتبلغ الأزمة ذروتها في ظواهر كـ«الزواج بين السياسة والمال» و«الحزب ذي الرؤوس الثلاثة»، وهي دلالات كاشفة لانكسار وحدة المرجعية داخل التنظيم الواحد، بما يحوّله إلى تجمّع مصالح أكثر منه حاملاً لمشروع سياسي متماسك. وهذه الظواهر ليست طارئة أو ظرفية، بل تعبّر عن تحوّل بنيوي يجعل الحزب يفقد وظيفته بوصفه «آلة لإنتاج المعنى»، ليصبح مجرّد أداة لتدبير المواقع وتوزيع الامتيازات.
وعليه، تبدو الأحزاب المغربية ضحية وسبباً في آنٍ واحد: ضحية لـ«العُقْدة الغوردية» التي تُفرغها من مضمونها التمثيلي، وسبباً في تعميق هذه العُقْدة حين تقبل التحوّل إلى وسيطٍ إداري يشتغل داخل منطق الفراغ الرمزي. فالوسائط الضعيفة تُسند عملياً مركزية الرمز، فيما تؤدي المركزية القوية، في المقابل، إلى إفقار الوسائط سياسياً ورمزياً.
ومن هذا المنظور، لا يجوز اختزال العزوف الانتخابي في كونه مجرّد عدم مشاركة في الاقتراع، لأنّ مثل هذا الفهم ينطوي على تبسيط مُخلّ. فالأدقّ اعتباره ممارسة لـ«سيميائية سلبية» واعية (Sémiotique négative)، أي شكلاً من أشكال التعبير الرمزي الصامت. ولا تفهم هنا «سيميائية الصمت» الانتخابي إلا بربطها بأنثروبولوجيا الممارسة السياسية المحلية، حيث تتقاطع المحاباة، والروابط العائلية، والمصلحية، مع أشكال الرفض الرمزي. فالصمت لا يعني دائماً اللامبالاة، بل قد يكون تعبيراً عقلانياً عن انسحاب مشروط من عملية لا تُنتج أثراً محسوساً.
في الواقع، إنّه استفتاء غير معلن يرفض فيه المجتمع التفاعل مع «دوالّ عائمة» فقدت مرجعيتها الواقعية. وحين يصمت الناخب، فهو لا ينسحب من السياسة، بل يُرسل شفرة سياسية قوية تُعلن انتهاء صلاحية الوسائط التقليدية، معتبراً أنّ اللغة السياسية السائدة باتت «لغة خشب» ميتة، لا تستحق الردّ إلا بالقطيعة.
العطب التمثيلي المركّب: من شيخوخة الأطر إلى انسداد الوساطة
إلى جانب هشاشة السرديات، تعاني الأحزاب السياسية من شيخوخة قيادية لا بوصفها معطى بيولوجياً، بل باعتبارها عطباً سيميائياً يمس قدرتها على تمثيل مجتمع فتيّ يتحوّل رقمياً وثقافياً بوتيرة سريعة. فالإشكال لا يكمن في السن، بل في تحوّل القيادة الحزبية إلى رأسمال بشري مغلق يُعاد تدويره عبر شبكات الولاء، لا عبر التداول والكفاءة. سيميائياً، يعكس هذا التصلّب فقدان العلامة الحزبية قدرتها على إنتاج المستقبل، وهو ما يفسّر عزوف الشباب بوصفه رفضاً رمزياً لنموذج حزبي لا يتكلم لغته ولا يحمل أفقه.
وفي مواجهة الخطاب الرسمي، يبرز الفضاء الرقمي كساحة لاشتباك رمزي جديد تُعاد فيه صياغة المعنى خارج قنوات الوساطة، حيث يُواجَه المعنى بالسخرية، والوسوم، وحملات المقاطعة العابرة أحياناً. وهو اشتباك لا يستهدف المؤسسات مباشرة، بقدر ما يفكّك المسافة بين الرمز الرسمي والواقع الاجتماعي، جاعلاً من التأويل اليومي ميداناً جديداً لمعركة الشرعية.
ولا يمكن اختزال هجرة السياسة في الفضاء الرقمي وحده، إذ تبرز على الهامش فاعليات جديدة—شبابية، مدنية، إبداعية—تنتج أشكالاً موازية من الفعل السياسي خارج القنوات التقليدية، من مبادرات محلية إلى احتجاجات موسمية وتجارب جمعوية. ورغم هشاشتها التنظيمية، فإنها تمثّل مختبراً لمعانٍ جديدة ووساطات محتملة، غير أن طبيعتها العابرة وهشاشتها تجعلها أكثر عرضة للاستقطاب أو الاحتواء، بما يحدّ من قدرتها على تفكيك تعقيدات العُقْدة الغوردية .
الهندسة الانتخابية: اقتراع يبرّد المعنى
في هذا السياق، لا تبدو انتخابات 2026 استحقاقاً سياسياً بالمعنى الكلاسيكي، بل أقرب إلى عملية ضبط للاتزان داخل نظام يقدّم الاستقرار على التمثيل، والهندسة على التنافس. فوظيفة هذا الموعد لا تتمثّل في إفراز خيار سياسي واضح، بل في إنتاج أغلبية قابلة للحكم، وجرعة شرعية كافية لعبور أفق 2030 بأقل كلفة اجتماعية.
ويعزّز هذا المنحى نظامٌ انتخابي لا يُسعف في فرز نخب سياسية مؤهلة، فيتحوّل الاقتراع من آلية للاختيار إلى أداة لإعادة تدوير النتائج نفسها، مهما تغيّرت الأصوات. ويشكّل القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المسجّلين قلب هذه الهندسة، إذ يُدخل الامتناع إلى صلب المعادلة، ويحوّل الصمت إلى وزن سياسي، ويمنع ترجمة التفوّق الشعبي إلى تفوّق تمثيلي، فارضاً التفتيت قاعدةً بنيوية.
ومع اختلال الخريطة الانتخابية وتغلغل المال، تتحوّل الانتخابات إلى سوق شرعية مفتوحة، حيث يملك الموارد من يملك التمثيل، لا من يملك البرنامج أو الثقة أو الكفاءة. وهكذا يصير البرلمان بنية فسيفسائية عاجزة عن إنتاج دلالات سياسية قادرة على مواكبة المشاريع الطموحة تشريعاً ومراقبةً.
إصلاح القواعد، تغيير أم إعادة إنتاج الاتزان؟
في هذا الإطار، تكتسي المشاورات الجارية حول تعديل القوانين الانتخابية دلالة تتجاوز بعدها الإجرائي، لتلامس جوهر الأزمة السياسية بوصفها أزمة معنى وتمثيل. ففتح ورش المراجعة يعكس وعياً مركزياً بأن قواعد اللعبة الحالية لم تعد قادرة على إنتاج الثقة، وأن استحقاقات 2026 لا يمكن تدبيرها بالمنطق نفسه دون تعميق فجوة العزوف والانسحاب الرمزي.
غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تعديل تقنيات معزولة، بل في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستقرار وضرورات الشفافية وتوسيع المشاركة. كما يطرح هذا الورش أعطاباً مؤجّلة، في مقدّمتها تمثيل مغاربة العالم، وحاجة العملية الانتخابية إلى مواكبة تربوية تعيد الإيمان بجدوى الصوت نفسه.
سيميائياً، تُقرأ هذه المشاورات كمحاولة لإعادة ترميم الشرعية الانتخابية قبل أفق 2026، غير أن نجاحها يظل رهيناً بتحويل القانون الانتخابي من أداة لضبط الاتزان، إلى رافعة لإعادة إدماج المواطن في السردية السياسية العامة.
استحقاقات 2026: نتائج مختلفة… ومعنى واحد
مهما اختلفت نتائج استحقاقات 2026، فإن منطق النظام يقود إلى الخلاصة نفسها: عدم إفراز أغلبية واضحة، وتشكيل حكومة يُحسم أمرها بعد الصندوق لا داخله. وهنا يتعمّق العطب السيميائي؛ إذ حين يشعر المواطن أن صوته لا يحسم، يفقد الاقتراع وظيفته الرمزية، وتهاجر السياسة إلى الاحتجاج أو السخرية أو اللامبالاة الغاضبة.
فخطر هذه الانتخابات لا يكمن في التكرار، بل في الفراغ: فراغ المعنى وفراغ الثقة. فالنظام قادر على إنتاج حكومات، لكنه مهدّد بالعجز عن إنتاج اقتناع. وحين تتحوّل الانتخابات إلى إجراء بلا أثر، يصبح الاستقرار نفسه هشّاً، لأنه يقوم على إدارة صامتة للانسحاب، لا على مشاركة حيّة.
وفي هذا السياق، تتحوّل الحكومة—أو استقالتها—إلى إيماءة بلا جمهور داخل نموذج «تحديث سلطوي» تُقدَّم فيه الإصلاحات كضرورات تقنية. ورغم نجاعتها التدبيرية، تعجز النخبة التكنوقراطية عن ملء الفراغ الرمزي، لأنها تشتغل بمنطق الحل لا بمنطق السردية، فتُسرّع هجرة المعنى بدل احتوائها.
ويتفاقم هذا الوضع مع إعطاب الوسائط التقليدية التي كانت تؤدي وظيفة الوساطة والتصفية النقدية. فقد تراجع دور المجتمع المدني والجامعة، وتحوّلت الصحافة من فاعل نقدي إلى بنية إدارية مُؤطَّرة، ما أفقد الدولة «ممتصّات الصدمات» الضرورية لاستقرار المجال العام، ووضعها في مواجهة مباشرة مع غضب رقمي غير مؤطّر.
وهكذا، لا تكمن خطورة المسار الراهن في راديكاليته، بل في تطبيع اللامعنى. فحين يعتاد المجتمع غياب الأفق السياسي، يتحوّل الانسحاب إلى سلوك عادي، ويغدو الاستقرار هشّاً لأنه لم يعد قائماً على مشاركة واعية، في ظلّ عجز الوسائط الحزبية عن استيعاب التحوّلات الرقمية وثقلها الدلالي.
ولا يمكن اختزال هجرة السياسة في الفضاء الرقمي وحده، إذ تبرز على الهامش فاعليات جديدة—شبابية، مدنية، إبداعية—تنتج أشكالاً موازية من الفعل السياسي خارج القنوات التقليدية، من مبادرات محلية إلى احتجاجات موسمية وتجارب جمعوية. ورغم هشاشتها التنظيمية، فإنها تمثّل مختبراً لمعانٍ جديدة ووساطات محتملة لم تنضج بعد في شكل قوة سياسية مؤطرة.
وتبلغ هذه الهجرة ذروتها في السرديات المضادة التي يقودها جيل رقمي جديد، يمارس «ثورة سيميائية» تهاجم دلالات خطاب حكومة «الكفاءات» من داخل الواقع المعاش. وسط هذا التنافر، تظل قضية الصحراء المغربية الدالّ المهيمن الذي يحافظ على تماسك السردية الوطنية، ويمنع انزلاق الأزمة السياسية إلى ضعف وجودي شامل. فرمز الوحدة الترابية يظل العلامة الوحيدة التي لا يمكن تفكيكها رقمياً أو التشكيك فيها حزبياً.
غير أن الرهان يبقى معلقاً: إلى أي حدّ تستطيع شرعية الإنجاز الصمود، إذا استمر اتساع الفجوة بين صورة المغرب «الحديث» وواقع العدالة الاجتماعية اليومية التي لم تستطع الأنظمة الحزبية ملأها؟
خاتمة: كيف تُفكّ العُقْدة الغوردية؟
تكشف هذه القراءة أن أزمة السياسة في المغرب هي، في جوهرها، أزمة معنى: حين يفقد الدالّ السياسي مدلوله الاجتماعي، تهاجر السياسة من المؤسسات إلى الصمت أو الاحتجاج. ولا تُفكّ «العُقْدة الغوردية» بقرارات تقنية، لأنها ليست خيطاً واحداً بل توازناً تاريخياً بين مركز الشرعية ووسائطها؛ لذلك يجب إعادة بناء «أفق سيميائي» مشترك.
إذ لا يكفي تعديل القوانين أو تغيير الوجوه، وبالأحرى، يجب تحويل السياسة من «علامة ميتة» إلى « دالّ حي» ينتج معنى قابلاً للمشاركة لا للاحتكار التأويلي. وهذا يتطلب خلق توازن جديد بين حداثة الدولة التقنية السريعة، وإدماج المواطن كفاعل في السردية الوطنية، وليس مجرد متلقٍ سلبي لإشارات لا يملك مفاتيح فكّها وتأويلها.
ويتطلب ذلك حركات متزامنة: تجديد العلامة الحزبية سردياً وجيلياً ووظيفياً، وإعادة بناء الجسور الوسيطة عبر جامعة ناقدة ومجتمع مدني فاعل، وفتح مساحات رمزية مشتركة تُعيد الاعتبار للسياسة كصناعة للأمل المشترك. وينطبق المنطق نفسه على السياسة الثقافية: ليست المشكلة في التحديث، بل في اختلال التوازن بين حداثة تقنية سريعة وتباطؤ في إدماج الفاعلين وخلق تداول رمزي حي يجعل المجتمع يرى نفسه داخل المشاريع لا تحتها.
فليست أزمة السياسة في المغرب أزمة غياب مشاريع أو نقص كفاءة، بل أزمة معنى: أزمة مجتمع لم يعد يرى نفسه فاعلاً داخل السردية، بل متلقياً لها. وحين يفقد السياسي قدرته على تسمية الأمل، يصبح الاستقرار نفسه معلقاً على صمت طويل لا على اقتناع حيّ.
وبالتحلي بالإرادة السياسية اللازمة، يمكن معالجة هذه العقدة على مستويات مختلفة:
أولاً على المستوى الرمزي: تجديد العلامة الحزبية سردياً وجيلياً، وإعادة بناء الجسور الوسيطة، وفتح مساحات مشتركة تُعيد للسياسة وظيفتها بوصفها منتجاً للأمل.
ثانياً على المستوى المؤسساتي والعملي: قد يمرّ هذا التجديد عبر تفعيل اللامركزية كحقل حقيقي لتجديد الوساطة المحلية، وربط تمويل الأحزاب بتجديد النخب والأداء، وإطلاق حوار وطني حقيقي—لا استشارياً—حول النموذج التنموي، بما يفرض على الفاعلين السياسيين تطوير سردياتهم وأدوات تمثيلهم.
وبالتالي فإن فكّ شفرة «الرمز الحقيقي» لا يمرّ عبر جولة أخرى من الإصلاحات التقنية وحدها، بل عبر إعادة الاعتبار لما هو سياسي بوصفه منتجاً للسردية ذي مصداقية ومعنى، ومؤسساً للتدافع البنّاء، ومستعيداً للأمل والثقة.